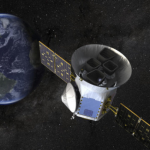ما يزال الصديق الدكتور أحمد المعتصم الشيخ يدهش قراء المكتبة السودانية بترجمات مميزة لأمهات الكتب في التاريخ والثقافة السودانية، والتميز مرده للاختيار الموفق للكتب والترجمة التي جمعت بين الثقافة الواسعة والمهنية في الأداء. فبعد سفر سبولدنج (عصر البطولة في سنار)، يدفع دكتور أحمد بإحدى روائع شيني (مروي حضارة سودانية).
وشيني الذي يعد أحد الآباء المؤسسين للآثار السودانية تميزت مسيرته بالتنوع في الخبرات الأكاديمية والعملية والتعدد في المناطق التي خدم فيها. فقد التحق شيني بوظيفة مساعد مفوض الآثار بحكومة السودان ثم ترقى مفوضا في العام 1948م، وانتقل بعد سنة واحدة إلى غانا مديرا للآثار بها ثم أستاذا لكرسي الآثار بجامعة غانا خلال الفترة (1958-1966م)، عاد بعدها أستاذا للآثار بجامعة الخرطوم. أتاح هذا التنوع للكاتب فرصة العمل والاستكشاف لمواقع أثرية متعددة في الحزام السوداني الذي يمتد من غرب افريقيا وحتى البحر الأحمر، هذا فضلا عن مشاركته في حملة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة.
وبالرغم من تعدد وتطور الاكتشافات والحفريات الأثرية التي أعقبت صدور الكتاب في نسخته الانجليزية ،في العام 1967م، إلا أن ما يميز كتاب (مروي حضارة سودانية) هو منظوره الذي يبرز مروي في سياقاتها الثقافية والحضارية ويدرسها كظاهرة مستقلة لا كمنطقة ضغط منخفض تشكلت عبر التأثيرات الخارجية سواء من الشمال أو الشرق. وقد عبر شيني عن منظوره ومنهجيته بالقول: ” ومهما يكن دور مروي في نشر الثقافة بين جيرانها، فإن تاريخها هي نفسها يقف علامة بارزة لا فريقيا القديمة. وقد حاول هذا الكتاب إبراز بعض هذا التأثير إلا أن مروي حضارة افريقية تقف بثبات على أرض افريقيا وقد طورها شعب افريقي، وأن دولة متمدنة و متحضرة ومتعاملة توجد في عمق القارة الافريقية واستطاعت العيش لما يقارب الألف سنة يمثل في حد ذاته إنجازا رائعا في غاية الأهمية” .
تعامل الكاتب بكثير من الصرامة مع تفسيرات وتأويلات الدلائل الأثرية ولم يستنكف عن الدفع بعدم وجود تأثيرات لمروي على اقاليم تشاد وشمال نيجيريا وأرجع ذلك للنوبة المسيحية، وأعطى وزنا كبيرا للحديد ودوره في التمدن وتعزيز القوة الحربية لمروي. وقد أورد شيني نماذج لاستمرار الثقافة السودانية من مروي وحتى الآن خاصة في بعض العادات والممارسات مثل الجرتق وغيره.
لقد أنفقت النخب السودا نية سحابة قرنها العشرين وهي تجادل وتحاور في الهوية، ولعل أوفق ما توصلت إليه طائفة أن السودان هو جسر بين العرب وأفريقيا. وكما ترى فالجسر والطريق لا هوية له بل ملحوق ومستتبع وجدواه ليست نابعة من ماهيته بل مما يقدمه للعابرين والنقاط الرابط بينها.
تؤسس هذه الوضعية الملتبسة للهوية لتأثيرات متعددة ؛ فهي تحرم السكان من الكينونة والانتساب والذي لا يتيسر الا بالالتحاق لأحد طرفي الجسر. وهي أيضا تجعل مصالح هذه الرقعة الجغرافية مرتبطة بشكل وجودي مع الطرفين الأمر الذي يفوت كثيرا من المصالح الحقيقية للمجموعات السكانية إن تعارضت وجوديا لا منفعيا مع الأطراف الأخرى.
بنت كثير من الدول اقتصادها على الهوية وهو الذي طورته بعضها لاستشراف آفاق الاقتصاد الإبداعي الرحبة .
والخطوة الأولى في هذا المشوار هو الوعي بالهوية، الهوية المميزة المتفردة للبلد التي تتيح لها بناء أمة متماسكة موحدة متفقة على حد معقول من المبادئ والمصالح والأهداف المشتركة.
: للهوية دور أساسي في التنمية، فقيم العمل الإيجابية وأشكال التضامن الاجتماعي وغيرها تعد روافع ضرورية لحركة التنمية. بل إن عمليات بناء الأمة ترتكز على اكتشاف الهوية الجامعة وتعزيزها وضمان عدم التعدي عليها، وتقدم تجارب دول كماليزيا والهند مثلا كيف للهوية أن تتقدم في معركة التنمية والتحديث.
تصنف ماليزيا في التجارب الرائدة لبناء الأمة، وهو عمل راشد مدروس بني اولا على تلمس ودراسة الهويات المتعددة وصياغة هوية جامعة للبلاد، هوية منتجة وعادلة فهي لا تقفز على الحقائق والظلامات بل تتعاطى معها وتنشئ برامج التمييز الإيجابي للمناطق والمجموعات السكانية المحرومة، وتسهر الأجهزة الحكومية على سلامة وسلاسة تنفيذ السياسات.
تؤكد كثير من الدراسات أن برامج بناء الأمة كان لها دور محوري في النهضة الماليزية، لأنها ببساطة دفعت بالجميع للمجرى الرئيسي لحركة التحديث وبنت مناهجها الدراسية على منظومة القيم الثقافية للمجتمع وكذا توجهات اعلامها، وكانت النتيجة تحول ضخم لدولة من فقر وعوز وتوترات اجتماعية إلى مصاف الدول الصناعية.
هذه دعوة للبحث والتنقيب في المكون الاقتصادي للهوية السودانية وبلورة سياسات تعين في صياغة برنامج طموح لبناء الأمة واستراتيجية شاملة للنهوض الحضاري.
د. علي محمد عثمان العراقي
خببير باللجنة الدولية لإدارة التراث الثقافي
ومحاضر بجامعة الملك سعود بكلية السياحة